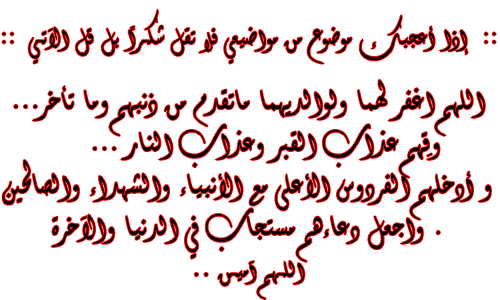نسيج التاريخ الإسلامي ومنظومة الحضارة الإسلامية
لم يبذل حتى الآن جهدٌ موضوعي كافٍ في مجال اعتماد التاريخ منطلقًا من المنطلقات الأساس لنهضة الأمة الإسلامية!
ففي المجال الثقافي ما زال تاريخنا الإسلامي يُتعامَل معه على أساس الانتقاء المذهبي، وإسقاط الأيديولوجية المسبقة، وعلى أحسن الفروض يتعامل معه على أساس أنه مجرد ذاكرة لماضي الأمة، وأن وقائعه يجب أن تخضع لمعايير التوثيق السليم، والعرض المنهجي التقليدي.
وفي المجال الدراسي التعليمي ما زال تاريخنا بعيدًا عن بناء إنسان مسلم عالمي، يتلقى التاريخَ على أساس أنه تاريخ كل المسلمين، وأنه المحاولة البشرية - بإيجابياتها وسلبياتها - لتطبيق المبادئ الإسلامية في الحياة، وأنه الترجمة الصادقة لفاعلية المسلمين في التاريخ الحضاري.
إنه يُقدَّم في كل بلد مسلم تقديمًا خاضعًا لنظام الحكم، وتُلْوَى عنقُ وقائعه؛ لتخدم التوجه السياسي لكل بلد، ولتساعد على تخريج جيل يؤمن بالنظام السائد، وببعض ما يرضى عنه النظام من فترات الماضي.
إنها لكارثة حقًّا أن تشكَّل مؤسسات للعرب جميعًا وللمسلمين جميعًا، وأن تعلوَ أصوات كثيرين بوَحدة المسلمين وبالتضامن الإسلامي، بينما يُفرَض على تاريخ المسلمين أن يسخَّر لتفتيت المسلمين، وغرس الإقليمية والقومية العنصرية، بل وتبرير بعض المذاهب المادية والعَلْمانية والإلحادية التي فرضها خصومُ المسلمين عليهم من جراء ضعفهم وتمزُّقهم، وعدم تعبيرهم التعبير الصحيح عن حقائق الإسلام ومنهجه في بناء الفرد، والأمة، والحضارة.
ووسط هذا الإجهاض لدور التاريخ في بناء نهضة الأمة، تقف هنا وهناك محاولاتٌ قليلة تشبه الشموع وسط ظلام حالك.
إنها محاولات تحاول تعميق النظرة في التاريخ نفسه، وليس تشريحه وَفْق خلفية مسبقة، وتوظيف رسمي، أو مذهب محدد.
وهي تحاول أن تنظرَ إلى وحدة التاريخ الإسلامي وتشابُكه على أساس وحدة الحضارة الإسلامية، حتى وإن اختلفت أساليب التعبير وأصداء الإيقاعات.
فمن فوق مناهج التمزيق الذي يعتمد عناصر الدولة، أو القوم، أو الأرض، أو اللغة - وحدها - أو كل عنصر على حدة - يقوم التشريح الإسلامي للتاريخ على أساس (الحضارة)، باعتبارها الوحدة القابلة للتنظير والتفسير الشمولي الموضوعي.
ولأن الإسلام كان دائمًا - حتى وإن خانتْه طائفة حاكمة، أو طائفة مذهبية خارجة عن انسجام الحضارة وأصولها - دينًا ينساب في كل أركان الحياة، ويتفاعل انطلاقًا من عقيدة المسلم الفرد وإيمانه وشريعته في مستواه وفي مستوى الجماعة؛ لأن الإسلام دين ملتصق بواقع الناس وشتى أركان حياتهم على هذا النحو المعروف، فإن الإسلام كان - دائمًا وما زال يشكِّل بنُظُمه ومؤسساته، وطوائفه المؤمنة، والعالمة، والصانعة، والزارعة، والمجاهدة - الخيوطَ الثابتة التي تصنع نسيج المجتمع وتحكُمُ علاقاته وثوابته، وعاداته وتقاليده.
وهذا النسيج المتصل بأركان الحياة الفردية والاجتماعية من كل زواياه لا يتأثر إلا قليلاً بالتحولات التي تقع في المستوى السياسي، ولا سيما وأنه إلى ما قبل التخلف الحضاري العلمي والفكري الذي وقع فيه المسلمون في مواجهة الحضارة الأوربية الحديثة - كان المسلمون - على الرغم من كل ما لحق بهم من هزات وتقلبات - هم أصحاب الحضارة العليا، وهم أساتذة الدنيا، وحتى لغتهم كانت الأولى في العالم التي تعتبر لغة الثقافة والحضارة.
وهذه الحقيقة الثابتة تُسقط - من ثمَّ - كلَّ التفسيرات السطحية التي وقفت كثيرًا عند بعض المعابر السياسية في التاريخ الإسلامي السياسي، مثل ما سمي (بالفتنة الكبرى) بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وما سمِّيَ بقيام دولة بني أمية، وظهور المُلْك العضوض وآثاره - في رأي بعضهم - ومثل سقوط بني أمية وقيام بني العباس، أو ظهور المماليك أو سقوطهم، إلى أن يصل الأمر إلى سقوط بني عثمان، وقيام عصر الدويلات الطائفية الأخيرة، وهو الحدث الذي يعتبر - بحق - من التحولات التاريخية الأسيفة، ليس لمجرد سقوط العثمانيين وخلافتهم، بل لأن هذا السقوط تبِعه تنحية شريعة المسلمين على المستوى الرسمي، وتفكك المسلمين على المستوى العقدي والفكري، وخضوعهم لتيارات (أيديولوجية) معادية للثوابت الإسلامية، وعجزهم عن المواجهة الموازية للتحديات الحضارية التقنية، والعلمية، والسياسية، والعسكرية، التي يتمتع بها الذين أسقطوا خلافة بني عثمان.
••••
إن سقوط بغداد سنة (656هـ) على يد التتار، لم يكن تحولاً حضاريًّا، وإن كان تحولاً سياسيًّا؛ ذلك لأن مبادئ الحضارة الإسلامية لم تلبث أن تفوَّقت على الغزاة المنتصرين، وحوَّلتْهم إلى جنود لها، كما أن العباسيين والأيوبيين والمماليك مثَّلوا جميعًا الحضارة الإسلامية على اختلاف في مستويات التعبير.
فخطُّ السياسة غير خط الحضارة إذًا.
وبالطبع فليس بوسعنا أن نتجاوز معبر سقوط الأندلس وغرناطة سنة (897هـ - 1492م)، فهنا صفحة طُويت وامتزجت بقايا إشعاعاتها بأرض المغرب العربي، ومع أنها (محطة) حقيقية يجب الوقوف طويلاً عند عوامل سقوطها، إلا أن المسلمين لم يتحدثوا عنها كما تحدثوا عن قيام بني أمية، وفتنة علي ومعاوية - رضي الله عنهما - مع أن الثانية ليست إلا تغيُّرًا في الشريحة السياسية والأسلوب السياسي في الحُكْم، وقد يكون تغيرًا له مبرراته التاريخية، بينما كانت الأولى (سقوطًا) و(انقطاعًا) حضاريًّا بكل معنى الانقطاع الحضاري في هذا الركن الجنوبي من أوربا، وللأسف فإن المنهج الخاطئ جعل كثيرًا من المسلمين يتحدَّثون عن أمجادهم في إسبانيا، دون أن يقدِّموا دراسات تفصيلية جادة ومكثفة عن أسباب سقوط الأندلس!
إن التفسير الإسلامي للتاريخ يجب أن يعيد ترتيب "المحاط" في دراسة التاريخ الإسلامي، اعتمادًا على (وحدة الحضارة) من جانب، وعلى (الحضارة) - كوحدة - من جانب آخر.
(فجسم) الحضارة الإسلامية - الذي هو الكيان المادي للمسلمين من تراب وإنسان - يجب أن يُنظَرَ إليه على أساس أنه وحدة.
كما أن (عقل) الحضارة الإسلامية، وما أفرزه من إبداعات في الفكر، والفن، والأدب، والفقه، والفلسفة، والعمارة، والزراعة، والصناعة - يجب أن يُنظَرَ إليه - كذلك - كوحدة.
و(رُوح) الحضارة الإسلامية، التي هي جوهرها وقلبها، هي وحدة كذلك بكل ما تضمُّه من عقيدة وأخلاق وتشريع وصياغة روحية للحياة؛ تؤمن بالغيب كما تؤمن بعالم الشهادات، وتستعين بذلك على صياغة الحياة، وتؤمن بوجود الله، وبعنايته، ورعايته لحركة الإنسان في التاريخ.
إنه - سبحانه وتعالى - يساعد الإنسان، ولا يكبِّله، ويحنو على خطاه، ويدفعها للأمام، ولا يجمدها أو يشدها إلى الخلف، وما الأنبياء والمرسَلون إلا منظمون لحركة الإنسان؛ حتى لا يحاول القفز من فوق السُّنن الكونية، وضوابط الحركة الاجتماعية، ويعبد ذاته، ويجعلها هدفًا، وينسى وظائفه الوجودية، وارتباطاته العليا بمسؤولية إنسانيته، وبوظيفة سامية في هذا الكون، إن ما يقدمه الأنبياء ليس تكبيلاً - كما يفهم الملحدون المتخلفون - وإنما هو شارات الطريق، وخريطة الفعل الحضاري التي تفرِّق بين المنطقة الصالحة للسير، والمنطقة المهلكة التي يموت فيها الإنسان، وتنهار الحضارة في أوحالها ورمالها المتحركة!
ونحن لم نجد في التاريخ حضارة مشتْ بدون هذه الشارات والضوابط، وتجرأت على المناطق الحرام، إلا كان مصيرها الزوالَ مهما امتدَّ بها العمر، وقد ورثها قوم آخرون مضوا وَفْق سنن الله والضوابط والشارات التي وضعها المرسلون من الله - سبحانه وتعالى.
ويعد من أهم ما يلتزم به التفسير الإسلامي للتاريخ أن يقسَّم تاريخ البشرية على ضوء تفاعلها مع رسالات الأنبياء ومستوى إيمانها بها، ومحاولاتها تقديم صياغة للحياة على ضوء الثوابت العقدية والتشريعية التي قدموها، أو - من جانب آخر - خروجها على هذه الثوابت، وما أصابها في مسيرتها من جرَّاء هذا الخروج.
وعندما يصل التاريخ البشري - من مراحل تعدُّده - إلى مرحلة نزول القرآن وظهور النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون قد انتهى إلى المرحلة القرآنية التي تتألق فيها الرسالةُ النبوية والإسلامية الشمولية، وبدءًا من هذا التاريخ تبدع الإنسانية المسلمة حضارةً تمتد إشعاعاتها إلى كل قارات الأرض.
ونحن نرى البشرية - هنا وبدءًا من هذه المرحلة الفاصلة - تنقسم بوضوح شديد أكثر من أي مرحلة سابقة إلى (إسلام) و(كفر)، أو (إسلام) و(وثنية)، وفي هذه المرحلة التي تعكس الهيمنة القرآنية، نرى امتزاج العقل بالوحي، ونرى تكاملاً يقدم للبشرية نموذجًا حضاريًّا وإنسانيًّا متوازيًا؛ يتكامل فيه إبداع الجسم مع العقل مع الروح.
وعندما كان المسلمون يمرون بمراحل التخلف، كان التوازن يختل، ويتفوق رصيد الجسم على رصيد العقل، أو رصيد الروح، وكانت النسب التعادلية تتعرض - بالتالي - لخلل جوهري، ينتهي إلى إفراز إبداع حضاري تنقصه بعضُ خصائص حضارة الإسلام، وقد تمر فترة من الوقت، ولا تلبث الموازين القرآنية الثابتة التي تكفَّل اللهُ بحفظها أن تفرز مصلحين يعيدون الفعاليةَ الإسلامية إلى توازنها في إطار ما يَقْوى عليه البشر، وما تسمح به خصائصهم الإنسانية.
ولا بد ونحن نؤطر للتنظير الإسلامي للتاريخ في المرحلة القرآنية أن ننظر إلى العالَم المسلم كوحدة، وأن ننظر إلى العالم غير المسلم كوحدة مضادة أو متقابلة، فهنا حضارة إسلام تمثِّلها أمَّة مسلمة أخرجت للناس، وهناك حضارة قائمة على التصورات الوثنية أو العقلية المحضة، ولم يستطع اللاهوت المسيحي أن يُخضِع التاريخَ الوسيط أو الحديث لأطروحاته؛ لأنه - أولاً - كان معزولاً عن الدنيا، ولأنه - ثانيًا - لم تكن له شريعة فاعلة، ولأنه - ثالثًا - لم يكن محتضنًا للعقل، بل كان محاربًا له، ولأنه - رابعًا - امتزج بالوثنية، وفَقَد ذاتَه الرُّوحية وتوحيدَه الإلهي منذ مجمع "نيقية" (325م)، كما أن اليهودية لم يكنْ لها وجود عالمي، أو مشروع حضاري إنساني، بل كانت - دائمًا - عقيدة عُنصرية قومية مغلقة!
••••
إنه على امتداد القرون التالية لميلاد الإسلام لم يكن هناك مشروع حضاري واضح القسمات والمنهج غير الحضارة الإسلامية.
ولو أن المسلمين لم يصابوا بالهمود الحضاريِّ، والتآكل الداخلي، والغياب عن فقه السُّنن الاجتماعية والكونية، ولو أنهم نجحوا في دخول عصر التقدم التقني الحديث، مسلَّحين بالعقل، والرُّوح، والمادة، مازجين به القراءة الإلهية التي قدمها الوحي: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1]، والقراءة الكونية: ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق: 3، 4]، لو أنهم فعلوا ذلك، لأمكن أن يتفوَّقوا على اليابان، وعلى النماذج الغربية الموجودة أمامنا.
وفي هذا الإطار، فإن تجربتهم في التاريخ كانت ستقدم لهم كثيرًا من مقومات الإقلاع الحضاري، وكانت ستكشف لهم - من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات - الخصوصيةَ الحضارية التي لن ينطلقوا بدونها، وكانت - بالتالي - ستوفِّر عليهم هذه الفوضى الفكريةَ، وهذه التبعياتِ المتتاليةَ للفكر الأوربي: شرقية أو غربية، وهذه الازدواجية المتناقضة بين الحكَّام والمحكومين، وبين بعض شرائح الحضارة الإسلامية التي تسمى دولاً وبعضها الآخر، وبين بعض المفكرين والمفكرين الآخرين، وكان في الإمكان أن يتحول الخلاف إلى تكامل، واختلاف الوسائل إلى مصب واحد في نهاية الأمر، ولربما نجح المسلمون في أن يوفروا قرونًا ثلاثة، تاهوا فيها في التاريخ، وبدَّدوا طاقات مادية ومعنوية لا يعلم حقيقتَها إلا الله.
••••
ولكي تكون صحوة الأمة حقيقة، فلا بد لها من دراسة ماضيها دراسة واعية شاملة، وهذا يقتضي منها بعث تجربتها التاريخية بعثًا جديدًا، وتَمثُّلَها تمثلاً جديدًا، لا يُكتفى فيه بالرصد السياسي، ولا بسلامة الرواية والنقل، ولا بالنقد الجزئي للمتن، بل بالإيحاء الشامل لماضي الحضارة الإسلامية، عبورًا بسلامة الوثائق، وبالنقد الجزئي، ووصولاً إلى تفسير إسلامي موضوعي للتاريخ.
••••
إن الوثائق لن تكون في المنهج التنظيري الذي ينشد التاريخ، بل إن أسهل شيء يقوم به الباحث أن يصل إلى المعلومات "الموثقة"، ثم يضمها إلى بعضها، ويقدم بعد ذلك إطارًا قد التصقتْ وقائعُه فصار تاريخًا.
إن الوثائق - بلا ريب - هي بعض عمل المؤرخ، لكن الأهم في عمل المؤرخ أن يعيش التاريخ، وأن ينقُلَه إلينا حياة نابضة نكاد نراها ونلمسها، ونشعر بكل تفاعلاتها وأركانها، وبما أن حياة الناس في التاريخ لم تكن جداولَ هندسية أو أرقامًا ميتة، أو جيوشًا منضبطة الحركة والإيقاع؛ فإن على المؤرخ أن ينقل إلينا التاريخ بكل بشريته وأمواجه المتلاطمة، والبواعث الفكرية والنفسية التي تقف وراء كل موجة.
إننا نقف - بيقين - مع المؤرخ الكبير (فلهام دلتاي) في مطالبته المؤرخ أن يستحضر الحياة مرة أخرى، وأن يحيا الحياة من جديد في نفسه، وإلا فَقَدَ التاريخُ ماهيته وجوهره، وبالتالي لن يكون مؤرخًا حقيقيًّا إلا مَن أوتي عمقًا وسَعة في حياته الرُّوحية الباطنية، يمكِّنانه مِن أن يحيا تجارِبَ الماضي مهما يكن من تنوعها وشدتها، ومَن أوتي فيضًا وخصبًا في هذه الحياة، ييسِّران له بعث الحياة في هذه المادة الميتة (الوقائع) التي استحالت إليها الحياة الماضية، ولم يعُدْ أمامه غيرها[1].
لكن (دلتاي) لم يقدم لنا الوسائل الكافية لإخراج الماضي من موته إلى الحياة، إنه يرشدنا إلى أن (الفردية المطلقة) القائمة على عدم التجانس وعلى صعوبة التركيب هي السبيل لهذا الإحياء، "فكما أن برجسون قد قال بأن الحيَّ يمتاز عما هو مادي بأنه يكوِّن كُلاًّ مستقلاًّ مقفلاً؛ لأنه مركَّب من أجزاء غير متجانسة يكمل بعضها بعضًا، فكذلك يقول (دلتاي): إن كل فرد يكوِّن كلاًّ مستقلاًّ مقفَلاً".
وعند (دلتاي) أن العظماءَ ما كانوا عظماء إلا لأنهم استطاعوا أن يجمعوا في نفوسهم كلَّ التيارات الروحية التي تضطرب بها رُوح الشعب أو الحضارة التي ينتسبون إليها، ليس عن طريق الإيغال فيها؛ لأن عملهم إنما هو تحقيق لرُوح العصر فيصبحون ممثليه[2].
وعلى أساس هذا التحديد الذي ذهب إليه (دلتاي)، كان الشعراء هم أقدرَ الناس - في رأيه - على تصوير الحياة في كل مظاهرها.
لكن رأي (دلتاي) - في أن (الفردية) التي تعني أن الفرد هو (مجتمع مصغر)، أو أن الفرد هو الممثِّلُ الصحيح والكامل للحضارة - رأيٌ فيه مبالغة؛ ففي كل مجتمع شذوذٌ يعبِّر عن النوازع البشرية الخاصة التي قد لا يمثل أصحابُها حضارتَهم، ومن جانب آخر فإن (الشعراء) ليسوا الممثلين الواقعيين لحضارتهم - كما ذهب (دلتاي) - وإن مثَّلوا بعضَ آمالها وآلامها.
بل إن تقدير الثوابت الحضارية في كل مجتمع شرطٌ ضروري لإعادة تمثيل الماضي وإحيائه، ومع إحياء الإيقاعات الفردية المتنوعة، فإن الفقه الموضوعي بروح الحضارة، ومسلماتها، وبيئتها، ومناخها الفكري والنفسي والروحي - هو أكبر ضمان لإمكانية استحضار التاريخ وتمثله؛ ذلك لأن البشر العاديين عندما يعبِّرون عن فرديتهم، فإنما يعبرون في فكرهم وسلوكهم عن إطار حضاري ينتمون إليه، إنهم أفراد وسط إطار عام، وهم يتحركون فوق أرض ورُوح في سياق واحد.
إن العقائد والأعراف والتقاليد الراسخة في كل حضارة هي التي تصوغ - إلى حد كبير - حياةَ الناس، ومن الصعب إدراكُ التنوع والفردية دون ربطهما بأُطُرِهما الثابتة، التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة توجيه الحياة وصبغها.
وباستثناء القلة الشاذة والمتمردة والمنسلخة في كل حضارة، فإن مجموع أبناء الحضارة الذين يتنوعون في التعبير، ويخضعون - في الوقت نفسه - لثوابتَ في التصور والسلوك يجعل منهم ممثِّلين لحضارة واحدة!
إن حضارة المسلمين تقوم على قِيَم تتمثل في أفكار وأنماط سلوكية، وأماكن تمارس فيها هذه السلوكيات، ووسائل تعبير مختلفة عن الفكر، ونماذج بشار بن برد، وأبي نواس، وابن الراوندي، وجماعات الزندقة، والحشاشين، والباطنية - هي الإيقاعات الشاذة المنسلخة.
لكن باستثناء هؤلاء وأمثالهم، فإن مجموع أفراد الأمة يعبرون عن إطار الحضارة الإسلامية.
فالعبادات المختلفة ترتبط بأزمنة وأمكنة وسلوكيات وصياغة لنشاطات الحياة وَفْق تعاليم الإسلام، وقد كان الناس يلتزمون بها، ويبرمجون حياتهم في الزمان والمكان والعملِ وَفْقها.
وتأتي النظم الإسلامية في المعاملات والسياسة والاقتصاد لتحدِّد أنماطًا سلوكية وفكرية تتكامل مع توجيهات العبادات.
وفي الوقت نفسه، فإن مختلف العبادات والمعاملات تقف على أرضية عقَدية تَحكُم المسلمَ في فكره وسلوكه - بنسبة إجمالية - وتحدِّد له مجال الحلال والحرام.
فمن المستحيل - على سبيل المثال - في مجتمعات المسلمين - في شتى عصورهم - أن تظهر علاقةُ الرجل بالمرأة على النحو الذي ظهرت به في الحضارة الإغريقية، أو تظهر به الآن في الحضارة الأوربية الحديثة.
وفي المجتمع الإسلامي لم يكن للربا السيطرةُ على الحياة الاقتصادية كما كان الحال في سيطرته على حياة العصور الحديثة، وأيضًا فإنه لطبيعة المبادئ الإسلامية في التكافل الاجتماعي من صور الإحسان الإلزامي، والزكاة، وحق الضيافة، والماعون، والأرحام، ونظام الميراث، والجار؛ فقد بقِي المجتمع الإسلامي بعيدًا عن ظاهرة الإقطاع والصراع الطبقي التي كان عليها حال العصور الوسطى.
وهكذا - في تصورنا - يمكن استحضار الحياة الماضية، واستعادة التاريخ عن طريق رصد الفردية المطلقة، بكل ما تمثِّله من ذاتية مغرقة، أو متجانسة بتعبير (دلتاي)، لكن ذلك لا بد أن يتم في إطار المنظومة الأساسية التي تتشكل منها حركةُ الحياة الفكرية والثقافية التي تصوغ العادات والتقاليد، وبقية الأنماط السلوكية الاجتماعية.
[1] عبدالرحمن بدوي: اشبنجلر، ص 40.
[2] اشبنجلر، ص: 41، 42.