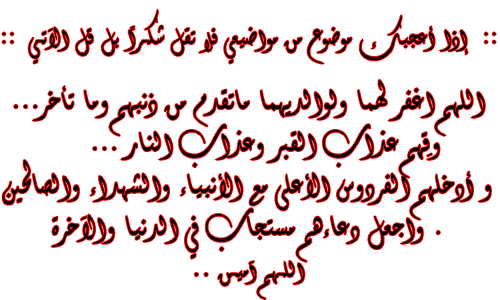روائع غزالية 2/ 3
عمر بن عبد المجيد البيانوني
حبُّ الدنيا:
- (حبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خطيئة، وأساسُ كلِّ نقصان، ومنبعُ كلِّ فساد، ومَن انطوى باطنه على حبِّ الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا ليتزود منها ولا ليستعين بها على الآخرة، فلا يطمعن في أنْ تصفو له لذة المناجاة في الصلاة، فإنَّ مَنْ فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته، وهمَّة الرجل مع قرَّة عينه، فإنْ كانت قرَّة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همُّه، ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة، وتقليل الأسباب الشاغلة، فهذا هو الدواء المر، ولمرارته استبشعته الطباع، وبقيت العلة مزمنة، وصار الداء عضالاً، حتى إنَّ الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا، فعجزوا عن ذلك، فإذن لا مطمع فيه لأمثالنا، وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس، لنكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وعلى الجملة فهمَّةُ الدنيا وهمَّةُ الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخل، فبقدر ما ندخل فيه من الماء يخرج منه من الخل لا محالة ولا يجتمعان).
- (إذا مالت قلوب العلماء إلى حبِّ الدنيا وإيثارها على الآخرة، فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة، ويطفىء مصابيح الهدى من قلوبهم، فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه، والفجور ظاهر في عمله، فما أخصبَ الألسن يومئذ، وما أجدبَ القلوب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا لأنَّ المعلمين علموا لغير الله تعالى، والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى).
- (فساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر، والله المستعان على كل حال).
- (الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، حتى نظروا في شواهدها وآياتها، ووزنوا بحسناتها سيئاتها، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها، ولا يفي مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصالها، ثم هي فرارة عن طلابها، شحيحة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها، إن أحسنت ساعة أساءت سنة، وإن أساءت مرة جعلتها سنة، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة، وتجارة بنيها خاسرة بائرة، وآفاتها على التوالي لصدور طلابها راشقة، ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة، فكل مغرور بها إلى الذل مصيره، وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره، شأنها الهرب من طالبها، والطلب لهاربها، ومن خدمها فاتته، ومن أعرض عنها واتته، لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات، ولا ينفك سرورها عن المنغصات، سلامتها تعقب السقم، وشبابها يسوق إلى الهرم، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم، فهي خداعة مكارة طيارة فرارة، لا تزال تتزين لطلابها، حتى إذا صاروا من أحبابها كشرت لهم عن أنيابها، وشوشت عليهم مناظم أسبابها، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها، فأذاقتهم قواتل سمامها، ورشقتهم بصوائب سهامها، بينما أصحابها منها في سرور وإنعام، إذ ولت عنها كأنها أضغاث أحلام، ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طحن الحصيد، ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد، إن ملكت واحدا منهم جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كأن لم يغن بالأمس، تمني أصحابها سرورا، وتعدهم غرورا، حتى يأملون كثيرا، ويبنون قصورا، فتصبح قصورهم قبورا، وجمعهم بُورا، وسعيهم هباءً منثورا، ودعاؤهم ثبورا، هذه صفتها وكان أمر الله قدراً مقدورا).
بين الدنيا والآخرة:
- (إنَّ الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم، فلا جرم مَنْ يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سمواته وأرضه، لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً؛ لأنَّ المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته ويلتذ به، ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره، بل يحصل بكثرة العارفين: زيادة الأنس، وثمرة الاستفادة والإفادة، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة؛ لأنَّ مقصدهم معرفة الله تعالى، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً فيما عند الله تعالى؛ لأنَّ أجلَّ ما عند الله سبحانه من النعيم لذة لقائه، وليس فيها ممانعة ومزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، نعم إذا قصد العلماء بالعلم: المال والجاه، تحاسدوا؛ لأنَّ المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر، ومعنى الجاه ملك القلوب، ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم، انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة، فيكون ذلك سبباً للمحاسدة، وإذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى، لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره بها وأن يفرح بذلك).
قيمة الوقت ونفاسته:
- (إنَّ العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة، بكى عليها لا محالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه، كان بكاؤه منها أشد، وكل ساعة من العمر بل كل نفس، جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها، فإنَّها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد، وتنقذك من شقاوة الأبد، وأي جواهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسراناً مبيناً، وإن صرفتها إلى معصية فقد هلكت هلاكاً فاحشاً، فإن كنت لا تبكي على هذه المعصية فذلك لجهلك، ومصيبتك بجهلك أعظم من كلِّ مصيبة، لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنَّه صاحب مصيبة فإنَّ نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته، والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فعند ذلك ينكشف لكلِّ مفلس إفلاسه، ولكل مصاب مصيبته، وقد رفع الناس عن التدارك).
القلب:
- (وليس لكلِّ إنسانٍ قلب، ولو كان لما صحَّ قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} فجعل من لم يتذكر بالقرآن مفلساً من القلب، ولست أعني بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر بل أعني به السر الذي هو من عالم الأمر واللحم الذي هو من عالم الخلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومملكته ولله الخلق والأمر جميعاً ولكن ذلك السر الذي قال الله تعالى فيه: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}، هو الأمير والملك لأنَّ بين عالم الأمر وعالم الخلق ترتيباً، وعالم الأمر أمير على عالم الخلق، وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، من عرفها فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربَّه).
- (وإنما الأهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذم إذ لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك مهلكات، وإهمالها من الواجبات، مع أن الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال، وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة كما يشير الطرقية من الأطباء بطلاء ظاهر البدن، وعلماء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب، وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب كما يفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة فلا يزال يتعب في الطلاء ويزيد في المواد وتتضاعف به الأمراض، فإن كنت مريداً للآخرة وطالباً للنجاة، وهارباً من الهلاك الأبدي، فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها، على ما فصلناه في ربع المهلكات، ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لا محالة، فإنَّ القلب إذا فرغ من المذموم امتلأ بالمحمود، والأرض إذا نقيت من الحشيش نبت فيها أصناف الزرع والرياحين، وإن لم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك، فلا تشتغل بفروض الكفاية لا سيما وفي زمرة الخلق من قد قام بها، فإن مهلك نفسه فيما به صلاح غيره سفيه، فما أشدَّ حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثيابه وهمَّت بقتله، وهو يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره، ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به، وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدناً لك وعادة متيسرة فيك، وما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فيها).
- (أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة، ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل الوظيفة الأولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف).
من آداب طالب العلم:
- (لا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين، وهو عين الحماقة، فإنَّ العلمَ سببُ النجاة والسعادة، ومن يطلب مهرباً من سبع ضار يفترسه، لم يفرِّق بين أنْ يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل، وضراوة سباع النار بالجهل بالله تعالى أشد من ضراوة كلِّ سبع، فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائناً من كان).
كيد الشيطان:
- (إذا لم يأمن من نبي من الأنبياء وهو في الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيره أن يأمن في دار الدنيا وهي منبع المحن والفتن ومعدن الملاذ والشهوات المنهي عنها).
- (مَنْ كان لله تعالى كان الله عز وجل له، ومن اشتغل بالله عز وجل ألقى الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوب كما سخر قلب الأم لولدها فقد دبر الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت، فمن شاهد هذا التدبير وثق بالمدبر واشتغل به وآمن ونظر إلى مدبر الأسباب لا إلى الأسباب).
بين العلم والمال:
- (الفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن اليد الأخرى، والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه، والمال أجسام وأعيان ولها نهاية، فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال يتملكه غيره، والعلم لا نهاية له ولا يتصور استيعابه، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه، صار ذلك ألذ عنده من كلِّ نعيم، ولم يكن ممنوعاً منه ولا مزاحماً فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق؛ لأنَّ غيره أيضاً لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته، فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة، فإنَّ نعيم العارف وجنته: معرفته التي هي صفة ذاته يأمن زوالها، وهو أبداً يجني ثمارها، فهو بروحه وقلبه مغتذ بفاكهة علمه، وهي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة، بل قطوفها دانية، فهو وإن غمض العين الظاهرة، فروحه أبداً ترتع في جنة عالية، ورياض زاهرة، فإن فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين، بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}، فهذا حالهم وهم بعد في الدنيا، فماذا يظن بهم عند انكشاف الغطاء، ومشاهدة المحبوب في العقبى).
السبيل إلى الجنة هو معرفة الله سبحانه:
- (الجنة لا مضايقة فيها ولا مزاحمة، ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً، فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعاً، بل الحسد من صفات المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين، ولذلك وسم به الشيطان اللعين، وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ما خص به من الاجتباء، ولما دعي إلى السجود استكبر وأبى، وتمرد وعصى، فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل، ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء، ويتحاسدون على رؤية البساتين التي هي جزء يسير من جملة الأرض، وكل الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء، ولكن السماء لسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد أصلاً، فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقاً أن تطلب نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر لها، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله عز و جل، ومعرفة صفاته وأفعاله، وعجائب ملكوت السموات والأرض، ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً.
فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله تعالى ولم تجد لذتها، وفتر عنها رأيك وضعفت فيها رغبتك، فأنت في ذلك معذور؛ إذ العنين لا يشتاق إلى لذة الوقاع، والصبي لا يشتاق إلى لذة الملك، فإن هذه لذات يختص بإدراكها الرجال دون الصبيان والمخنثين، فكذلك لذة المعرفة يختص بإدراكها الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولا يشتاق إلى هذه اللذة غيرهم؛ لأنَّ الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي مع المحرومين في أسفل السافلين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين).
قلة العلماء الربَّانيين:
- (فقد الطبيب هو الداء العضال، فإنَّ الأطباء هم العلماء وقد مرضوا فى هذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا عن علاجه، وصارت لهم سلوة فى عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم، فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضاً؛ لأنَّ الداء المهلك هو حبُّ الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافاً من أن يقال لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم، فبهذا السبب عمَّ على الخلق الداء، وعظم الوباء، وانقطع الدواء، وهلك الخلق لفقد الأطباء، بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا، وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم فى مواعظهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم، ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة؛ لأنَّ ذلك ألذ في الأسماع وأخف على الطباع، فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جراءة على المعاصي، ومزيد ثقة بفضل الله، ومهما كان الطبيب جاهلاً أو خائباً أهلك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه، فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضادي العلة.
أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية، وكلف نفسه ما لا تطيق، وضيق العيش على نفسه بالكلية، فتكسر سورة إسرافه فى الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال، وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقت يعالج أيضاً بأسباب الرجاء حتى يطمع فى قبول التوبة فيتوب.
فأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء، وذلك من دأب الجهال والأغبياء، فإذن فساد الأطباء هي المعضلة الزباء التي لا تقبل الدواء أصلاً).
الحذر من الجدل المذموم:
- (أما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة، وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات، ما لم يعهد مثلها في السلف، فإياك وأن تحوم حولها، واجتنبها اجتناب السم القاتل، فإنها الداء العضال، وهو الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة، وهذا الكلام ربما يسمع من قائله فيقال: (الناس أعداء ما جهلوا)، فلا تظن ذلك، فعلى الخبير سقطت، فاقبل هذه النصيحة ممن ضيَّع العمر فيه زماناً، وزاد فيه على الأولين تصنيفاً وتحقيقاً وجدلاً وبياناً، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه، فهجره واشتغل بنفسه، فلا يغرنك قول مَنْ يقول: (الفتوى عماد الشرع، ولا يعرف علله إلا بعلم الخلاف)، فإنَّ علل المذهب مذكورة في المذهب، والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة، وكانوا أعلم بعلل الفتاوى من غيرهم، بل هي مع أنها غير مفيدة في علم المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه، فإنَّ الذي يشهد له حدس المفتي إذا صح ذوقه في الفقه، لا يمكن تمشيته على شروط الجدل في أكثر الأمر، فمن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضيات الجدل، وجبن عن الإذعان لذوق الفقه.
وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاه، ويتعلل بأنه يطلب عِلَل المذهب، وقد ينقضي عليه العمر ولا تنصرف همته إلى علم المذهب، فكن من شياطين الجن في أمان، واحترز من شياطين الإنس، فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال، وبالجملة فالمرضي عند العقلاء أن تقدر نفسك في العالم وحدك مع الله، وبين يديك الموت والعرض والحساب، والجنة والنار، وتأمل فيما يعنيك مما بين يديك، ودع عنك ما سواه والسَّلام).
المال والجاه:
(إنَّ الجاه والمال هما ركنا الدنيا، ومعنى المال: ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه: ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها، وكما أنَّ الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير، أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس، فكذلك ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناس، أي يقدر على أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه.
وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات، فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات، ولا تصير القلوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات، فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوصاف الكمال انقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب، وبحسب درجة ذلك الكمال عنده، وليس يشترط أن يكون الوصف كمالاً في نفسه، بل يكفي أن يكون كمالاً عنده وفي اعتقاده، وقد يعتقد ما ليس كمالاً كمالا، ويذعن قلبه للموصوف به انقياداً ضرورياً بحسب اعتقاده، فإن انقياد القلب حال للقلب.
وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها، وكما أنَّ محبَّ المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد، فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدهم ويملك رقابهم بملك قلوبهم، بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم؛ لأنَّ المالك يملك العبد قهراً والعبد متأب بطبعه ولو خلى ورأيه انسل عن الطاعة، وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعاً ويبغي أن تكون له الأحرار عبيداً بالطبع والطوع، مع الفرح بالعبودية والطاعة له، فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير.
فإذن معنى الجاه قيام المنزلة في قلوب الناس، أي اعتقاد القلوب لنعت من نعوت الكمال فيه، فبقدر ما يعتقدون من كماله تذعن له قلوبهم، وبقدر إذعان القلوب تكون قدرته على القلوب، وبقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاه.
فهذا هو معنى الجاه وحقيقتة وله ثمرات كالمدح والإطراء، فإنَّ المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقده فيثني عليه، وكالخدمة والإعانة فإنَّه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده، فيكون سخرة له مثل العبد في أغراضه، وكالإيثار وترك المنازعة، والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام، وتسليم الصدر في المحافل، والتقديم في جميع المقاصد، فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في القلب، ومعنى قيام الجاه في القلب اشتمال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال في صورة، أو قوة في بدن أو شيء مما يعتقده الناس كمالاً، فإنَّ هذه الأوصاف كلها تعظم محله في القلوب فتكون سبباً لقيام الجاه).
علاج حب الجاه:
- (إنَّ مَنْ غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغوفاً بالتودد إليهم والمراءات لأجلهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها، وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب، إذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل، وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها وذلك هو عين النفاق، فحب الجاه إذا من المهلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب فإن طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال).
- (علاج الجاه أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه، وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم، وذلك إن صفا وسلم فآخره الموت، فليس هو من الباقيات الصالحات، بل لو سجد لك كل من على بسيط الأرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له، ويكون حالك كحال من مات قبلك من ذوي الجاه مع المتواضعين له، فهذا لا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها، ومن فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي كما سبق صغر الجاه في عينه، إلا أن ذلك إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة، ويكون الموت كالحاصل عنده، ويكون حاله كحال الحسن البصري حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز: (أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات)، فانظر كيف مد نظره نحو المستقبل وقدره كائناً، وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب في جوابه: (أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل)، فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة فكان عملهم لها بالتقوى؛ إذ علموا أن العاقبة للمتقين فاستحقروا الجاه والمال في الدنيا.
وأبصار أكثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة التي لا يمتد نورها إلى مشاهدة العواقب، ولذلك قال تعالى: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} وقال عز وجل: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ}، فمن هذا حده فينبغي أن يعالج قلبه من حبِّ الجاه بالعلم بالآفات العاجلة، وهو أن يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا، فإنَّ كل ذي جاه محسود ومقصود بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه ومحترز من أن تتغير منزلته في القلوب والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها وهي مترددة بين الإقبال والإعراض.
فكلُّ ما يُبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يُبنى على أمواج البحر، فإنه لا ثبات له، والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء، كلُّ ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة الجاه، فلا يفي في الدنيا مرجوها بمخوفها، فضلاً عما يفوت في الآخرة، فبهذا ينبغي أن تعالج البصيرة الضعيفة، وأما من نفذت بصيرته وقوي إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا).
- (مَنْ أحب الجاه والمنزلة فهو كمن أحب المال بل هو شر منه، فإنَّ فتنة الجاه أعظم، ولا يمكنه أن لا يحب المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في الناس، فإذا أحرز قوته من كسبه أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأساً أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال، فلا يبالي أكان له منزلة في قلوبهم أم لم يكن، كما لا يبالي بما في قلوب الذين هم منه في أقصى المشرق؛ لأنه لا يراهم ولا يطمع فيهم، ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة، فمن قنع استغنى عن الناس، وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس، ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن، ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع).