الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم
الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم
الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم
الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم
لا يتردد الشخص في الحكم بأن من البدهيات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ دولةً إسلاميةً في زمنه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان رئيسًا وحاكمًا على هذه الدولة.
ولم تكن هذه القضية محلاً للخلاف لدى الخطاب الإسلامي في هذا العصر، ولذا فإنا سنتجاوز ذلك ونتوجه إلى دراسة قضية غدت تظهر في نوادينا الثقافية وفي بعض سجالاتنا المعرفية، وهي قضية البحث في الآلية التي أصبح بها النبي صلى الله عليه وسلم رئيسًا للدولة، وتحديد العملية التي أسست الشرعية السياسية له، التي أصبح من خلالها حاكمًا على دولة الإسلام.
وهذه القضية لم تكن مطروحة في الفكر الإسلامي قديمًا، ولهذا ربما لا يجد الباحث كلامًا مباشرًا لعلماء الإسلام فيها، وإنما حدث البحث فيها مع حالة الاحتكاك المعرفي والسياسي بين الفكر الإسلامي والفكري الغربي في عصرنا الحديث.
وإذا أردنا أن نقوم بدراسة هذه القضية ونتوصل إلى تحرير القول الصحيح فيها، وننتهي إلى الكشف عن الموقف الذي يمثل حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أولاً أن نقوم بجمع الشواهد التاريخية التي تتعلق بالموضوع ، ولا بدّ من الحذر كل الحذر من الاعتماد على بعضها وإغفال البعض الآخر، وعلينا ثانيًا أن نقوم بتحليلها تحليلاً علميًّا يصور الواقع كما هو ولا نبالغ أو نتوسع في التحليل ونضيف أفكارًا خارجة عن النسق الخاص بتلك الشواهد.
والحوادث التاريخية التي تمثل مخزونًا معرفيًّا في مثل هذه القضية هي الوثائق والمبايعات والكتابات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب، وقد اهتم المؤرخون بجمعها وتتبعها، ولعل من أجمع المؤلفات التي احتوت قدرًا كبيرًا منها كتاب (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة)، تأليف محمد حميد الله، وبلا شك فليس كل ما جاء فيه صحيح أو موثوق به، ولكن ثمة قدرًا كبيرًا مما احتواه من الوثائق ثابت تاريخيًّا، فهذا الكتاب يعد موسوعة ضخمة من الشواهد التاريخية الهامة، وقد تضمن مباحث عالية الجودة في السياسة الشرعية، وفي تصوري أنه لو قام باحث بتحليل المضامين السياسية التي احتوى عليها لخرج بمعلومات مهمة جدًّا.
وقد حاولت أن أقوم من خلال قراءته وقراءة بعض كتب السيرة النبوية بجمع الشواهد التاريخية التي تتعلق بقضية رياسة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة في زمنه، وقد تفاجأتُ من كثرة المادة العملية ومن تنوع دلالتها ومقتضياتها.
فهناك عشرات الشواهد اشتركت في الدلالة على معنى واحد وهو أنّ نبوته صلى الله عليه وسلم تؤسس له الاستحقاق في الإمامة على الدولة وتحقق له الشرعية التي يمارس بها ذلك الحق، وتدل أنّ الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومبايعته على ذلك متضمنة للإقرار بأنّه صلى الله عليه وسلم رئيس للدولة وحاكم عليها، وأنّ الإيمان به يكفي في تأسيس المشروعية السياسية له صلى الله عليه وسلم، ولا أنّه لا يحتاج إلى مبايعة أو عقد آخر يؤسس له المشروعية.
ومن الصعب جدًّا سرد كل الشواهد التاريخية الدالة على هذا الرأي، ولكن يمكن تصنيفها وتقسيمها إلى أنواع بحسب دلالاتها، وهي كالتالي:
النوع الأول: الشواهد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يخاطب الرؤساء ويعدهم بأنّهم إذا آمنوا به يجعل لهم ما تحت أيديهم ويوليهم عليه؛ ومن ذلك ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي، شيخ اليمامة، وفيه: «سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعلُ لك ما تحت يديك»(1)، ومن ذلك أيضا ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان وفيه: «إنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرّا بالإسلام فإن ملككما زائل»(2)، ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى همدان، وفيه: «إنّكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة، فإنّ لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وأموالكم، وأرض البور التي أسلمتم عليها، سهلها وجبلها، وعيونها وفروعها، غير مظلومين ولا مضيق عليكم»(3).
وهذا الحكم السياسي تكرر من النبيّ صلى الله عليه وسلم في عدد من كتبه التي أرسل بها إلى القبائل العربية، ككتابه إلى معد يكرب من خولان، وخالد بن ضمّاد من أزد، وأبي طبيان الأزدي من غامد، وبني عامر بن الأسود من طيّء.
ووجه الشاهد من هذا النوع هو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مارس الحكم السياسي وعلّق ذلك على مجرد الإيمان به وبدينه، ولو كان لا يملك الشرعية السياسية بذلك لما فعله، ولو كانت شرعيته السياسية متوقفة على مبايعة خاصة غير مبايعة الإيمان به لتوقف عن إصدار ذلك الحكم.
النوع الثاني: الشواهد التي فيها أنّه صلى الله عليه وسلم كان يعين نوابًا عنه على القرى والقبائل التي أعلت إيمانها به، وهذا النوع تدخل تحته شواهد كثيرة؛ ومن ذلك: تعيينه لقيس الهمداني على قومه، فقد جاء في كتابه إليه: «فإنّي استعملتك على قومك غربهم وأحمرهم ومواليهم»(4)، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزياد بن الحارث لما جاء بخبر إسلام قومه :"ألا أؤمرك عليهم؟"، فقال: بلى يا رسول الله، فكتب له كتابًا، ومن ذلك؛ تعيينه لوائل بن حجر رئيسًا على قومه(5)، وكذلك ولّى الرسول صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد نائبًا عنه في مكة وعثمان بن أبي العاص في الطائف.
ووجه الشاهد من هذا النوع هو أنّه صلى الله عليه وسلم حكم بأحكام سياسية اعتمادًا على مبايعته على الإيمان به، ولم يَرد أنّه طلب منهم أن يبايعوه على أن يكون حاكمًا على الدولة حتى يمارس الحكم السياسي، وهذا يدل على أنّ مجرد الإيمان به قدر كاف في تأسيس الشرعية السياسية له لأنّها متضمنة فيها.
النوع الثالث: الشواهد الدالة على أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصدر بعض الأحكام السياسية على البلاد التي آمن أهلها خارج المدينة، ومن ذلك كتابه إلى قبيلة بارقة، وفيه: «هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق: أن لا تُجز ثمارهم، وأن لا تُرعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق»(6)، ومن ذلك كتابه لربيعة بن ذي المرحب من حضرموت، وفيه: «أنّ لهم أموالهم ونخلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم»(7)، ومن ذلك كتابه لعوسجة بن حرملة الجهني وفيه: «هذا ما أعطى الرسول عوسجة بن حرملة الجهني من ذي الرمة أعطاه ما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة»( .
.
ووجه الشاهد من هذا النوع أنّه صلى الله عليه وسلم حكم بحكم سياسي ونقذ حكمه في القوم الذين لم يذكر عنهم إلا أنّهم بايعوه على الإيمان به واتباع دينه، وهذا يدل على أنّ الإيمان به متضمن للإقرار بكون حاكمًا ورئيسًا سياسيًّا.
النوع الرابع: الشواهد التي فيها أنّه صلى الله عليه وسلم أقر القبائل التي ربطت بين الإيمان به وبين شرعيته السياسية، ومن ذلك إقراره لقبيلة مذحج، فإنهم حين وفدوا لمبايعته على الإيمان قالوا: "إسلامنا على أنّ لنا من أرضنا ماؤها ومرعاها وهدالها"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك على مذحج وعلى أرض مذحج من حشد ورفد وزهر»، فكتب لهم رسول الله كتابًا على ذلك(9)، ومن ذلك أنّه صلى الله عليه وسلم حين دعا بني عامر بن صعصعة قال له رجل منهم: "أريت إن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟" قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»(10)، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ربطهم بين الإيمان به وبين الإقرار بكونه رئيسًا للدولة، ولكنه أنكر عليهم طلبهم لتوريث الرياسة.
ووجه الشاهد من هذا النوع هو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ الربط بين الإيمان به وبين كونه رئيسًا للدولة، فلو كان لا يملك الشرعية السياسية بمجرد الإيمان به لأنكر ذلك الربط ولصرح بنفيه.
فهذه الشواهد تواردت كلها على تأكيد معنى واحد وهو أنّ سيادة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية تتحقق بمجرد الإيمان به، وأنّه لا يُحتاج في تأسيس شرعية حكمه السياسي إلى مبايعة أخرى تثبت رضا الناس المؤمنين بنبوته بكونه حاكمًا للدولة، لأنّ هناك ترابط ضمني بين الإقرار بالإيمان به وبكونه رسولاً وبين الإقرار والرضا بكونه يملك الشرعية السياسية التي يصدر من خلالها أحكامًا سياسية نافذة، وهذا الترابط هو المنسجم مع طبيعة الإقرار بنبوته، فمن المستبعد عقلاً أن يقرّ الإنسان الكافر بكونه رسول الله وأنه معصوم ومؤيد من السماء ومشرّع للأحكام، ثُمّ بعد ذلك لا يقرّ ولا يرضى بكونه حاكمًا على الدولة ولا يثق في نزاهته السياسية أو عدله وسعة نظرته في إدارة شؤون البلاد.
إنّ الإقرار بالنبوة والتسليم بها قضية مركبة تتضمن أشياء عديدة تتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، إنّه يعني الإقرار بصدقه، وعدله، ونزاهته، وحنكته، وتقواه، وقوة عقله، وقلبه، وقوة بصيرته، وشدة الحب له، والتعظيم لشأنه، والتوقير لشخصه، والخضوع لأمره، وتقديم رأيه، والارتياح لمشورته، والرغبة في الانقياد به، والاتباع لما يريد، وتحقيق ما يسعده ويفرحه، فمن المستبعد أن يقرّ الإنسان المسلم بكل هذه الأمور ثُمّ في النهاية لا يقرّ بكونه حاكمًا على الدولة، ولا يرضى له بالشرعية السياسية حتى يحتاج إلى أن يبايعه مبايعة أخرى يقرر فيها رضاه بحكمه السياسي، إنّ هذا الفصل يبدو مستبعدًا جدًّا لا يكاد يتصوره الإنسان.
ومما يقوي التداخل والترابط بين الإيمان به وبين الرضا بإمامته للدولة في نفسية المسلم؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سالم من جميع الموانع التي تمنع من الرضا بشرعية أي حاكم من البشر، فمن المعلوم أنّ الشعوب إنّما تمتنع عن الرضا بالحاكم إما لعدم ثقتها في عدله، أو علمه، أو نزاهته، أو أنّها تعتقد أنه لا يستحق الشرعية لنقص في خُلقه، أو جسده، أو نسبه، وكل هذه الأمور منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الكمال في أوصاف المحامد كلها، وبالتالي فتصور الفصل بين الإيمان به وبين عدم الرضا بإمامته يبدو بعيدًا ومستعصيًا على التصور السليم.
ولهذا كان المسلمون يربطون بين مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين كونه حاكمًا سياسيًّا يملك الشرعية في إصدار الأوامر السياسية، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضعيفًا من المسلمين في مكة بالهجرة إلى الحبشة، امتثل الصحابة ذلك، ولم يشيروا إلى الفرق بين مقتضى نبوته وبين أوامره السياسية مع ما في ذلك الأمر السياسي من الغربة والمشقة، وكذلك الإلزام بوجوب الهجرة قبل فتح مكة، فهذا الأمر السياسي كان ممتثلاً من الصحابة، ومن يخالفه يعد داخلاً في دائرة الذم.
ولو قُدر أن قبيلة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحين أمرها بأمر سياسي جازم لم يمتثلوا أمره ولم يكن لهم مبرر إلا التفريق بين مقتضى النبوة بين شرعيته السياسية لكان فعلهم ذلك محلاً للإنكار، فلو اقترضنا أنّها قالت: ما على هذا كانت المبايعة، هل سيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقبل به؟!! وهل سيَعُدُّ ذلك أمرًا مقبولاً لأنّه لم يتم الاتفاق عليه في مبايعة الإيمان؟!! أم سيكون صنيعهم ذلك محلاً للإنكار والذم الشديد؛ ومثله في الحال لو قُدر أنّ المزارعين الذين أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك تأبير النخل قالوا: أمرك هذا غير ملزم لنا لأنّا لم نبايعك إلا على الإيمان، هل سيكون صنيعهم هذا مقبولاً، أم سيكون محلا للذم والإنكار؟!!
ولا بدّ من التأكيد هنا على أنّه ليس معنى الكلام السابق أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أصبح رئيسًا للدولة بالجبر ومن غير رضا الناس بذلك، وإنما معناه أنّ رضا الناس بولايته السياسية تحقق تلقائيًا بمجرد الإيمان به، وأنّهم لم يفصلوا بين الأمرين المترابطين.
جواب على اعتراض
ربما يعترض معترض على التقرير السابق بما حدث في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في العقبة، فمن المعلوم أنه بايعهم مبايعتين، كانت الأولى على الإيمان به، وكانت الثانية على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فقد يستنتج البعض بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم مع استحقاقه لأن يكون إمامًا على الدولة في زمنه إلا أنّه لم يصبح حاكمًا على المدينة يجب له حق السمع والطاعة -أي أنه يمتلك الشرعية السياسية- إلا بعد أظهر الأنصار رضاهم بذلك وأعطوه الإذن بحكمهم، ولو لم يعطوه لما ملك النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية السياسية عليهم، وسيصبح مجرد نبي مبلغ عن الله تعالى دينه فقط.
ولكن الاستناد إلى هذه الحادثة في تأسيس الفصل بين الإقرار بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبين الرضا بإمامته السياسية غير صحيح، فهذا هذا الاستدلال مبنيّ أولاً على اختزال شديد للشواهد التاريخية، فهو لم يتعمد إلا على شاهد واحد وأغلف عشرات الشواهد التي تدل على نقيض ما فهمه من قضية مبايعة الأنصار.
وهو ثانيًا مبني على فهم غير دقيق لحادثة بيعة العقبة، فلو رجعنا إلى تلك الحادثة وقمنا بتحليلها وتفسيرها وفق المجريات في تلك المرحلة وراعينا الحالة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشها الأنصار المبايعين سنكتشف بأنها لا تدل على الفصل بين الإيمان بالنبي وبين الإقرار بإمامته السياسية بحال، وأنه لا علاقة لها بذلك.
وحتى تتبين صورة القصة بوضوح علينا أن نعرض أهم فقراتها، فالقصة باختصار تقول: هناك عدد قليل جدًا من يثرب قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا للحج وآمنوا به، وبايعوه كما يبايعه سائر الناس على بيعة الإيمان وهي كما قال عبادة رضي الله عنه: قال لنا رسول الله: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء الله عفا عنه»(11).
ورجع ذلك العدد إلى يثرب وآمن بسببهم وبدعوة مصعب بن عمير عدد كبير من أهلهم، ولم يبق دار من دور المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، وتكونت بهم جماعة لها قوة ومنعة، وفي موسم الحج المقبل ذهبوا إلى مكة وأخذ الأنصار يتساءلون فيها بينهم إلى متى يتركون رسول الله يطوف ويطرد في جبال مكة وهو خائف على نفسه، فجرت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد مكان وزمان اللقاء بينهم، فلما اجتمعوا، تحدث العباس -وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا معشر الخزرج -وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها- إن محمدًا منّا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده".
ومن خطاب العباس يظهر أن موضوع الاتفاق ليس هو البحث عن الشرعية السياسية للنبي وإنما عن توفير الحماية والأمن له ولدينه من أعدائه.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»، فأخذ البراء بن معرور بيده، وقال: "نعم، فوالذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرًا عن كابر".
فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها- يعنى اليهود- فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم»(12).
فلما أبدى الأنصار استعدادهم لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في المدنية ووعْدُهم بحمايته ووعد النبي لهم بعدم تركهم، طلب منهم أن يُخرجوا له اثني عشر نقيبًا ليبايعوا على ذلك، فتمت المبايعة، وهي كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله".
فهذه هي القصة باختصار ومن خلال تحليلها يظهر للقارئ بأن موضوع الاجتماع الثاني لم يكن في البحث عن الشرعية السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في البحث عن الآلية التي يكون بها رئيسًا على الدولة ولا حاكمًا عليها، وإنما كان الاجتماع في بحث قضية واحدة وهي تحديد الضمانات التي يحمي بها الأنصار النبيُّ من أعدائه والمتربصين به من العرب.
فلم يكن هدف النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة الثانية التأكد من رضا الأنصار برياسته للدولة ولا التحقق من رغبتهم في ذلك، ولم يكن هدف الأنصار منها إظهار رضاهم بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكشف عن محبتهم لسياسته لحياتهم ودولتهم، فهم قد أظهروا ذلك في إعلان إيمانهم به، وإنما كان الهدف من الطرفين الاتفاق على الحماية وتوفير الأمن للنبي ولدينه، ولهذا سميت هذه البيعة بيعة القتال.
ومن الطبيعيّ جدًا أن يكون موضوع ذلك الاجتماع البحث في ضمانات الحماية، ومن الطبيعيّ أن يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأنه سينتقل إلى المدينة ويبتعد عن أهله وأقاربه الذين كانوا يحمونه من أعدائه، وليس من المعقول أن يفعل ذلك من دون أن يقدم له الأنصار الضمانات الكافية.
ومبايعة الأنصار على السمع والطاعة ليس معناه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم تكن له الشرعية السياسية إلا بعد تلك المبايعة، وليس معناه أنه لا يحق له ممارسة العمل السياسي إلا بعد أن أبدى له الأنصار الرضا بذلك في مبايعة خاصة غير مبايعة الإيمان، وفي المقابل ليس معناه أن الأنصار لم يبدو له الرضا بإمامته السياسية إلا في تلك البيعة، كل هذه المعاني ليست داخلة ضمن بيعة العقبة الثانية، وإنما معنى التنصيص على السمع والطاعة التأكيد على نفوذ حكمه صلى الله عليه وسلم لا لتأسيس الشرعية السياسية له، ولهذا كانت تسمى بيعة العقبة الثانية بيعة الأمراء، وسميت بذلك -كما قال أبو العباس القرطبي- لأن المقصود منها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء.
ويدل على هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يبايع الصحابة عند كل حادثة كبيرة كما فعل في الحديبية في بيعة الرضوان، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت"(البخاري)، فتلك المبايعة لم تكن لتأسيس الرضا بحكم النبيّ لأن الصحابة قد رضوا بذلك بلا شك، وإنما لتأكيد رضاهم.
وبهذا التحليل يظهر للقارئ بأنه الاعتماد على بيعتي العقبة في الحكم بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكتسب الشرعية السياسية إلا بعد مبايعة خاصة برضا الشعب بذلك غير صحيح.
المصدر: موقع التاريخ.1- مجموعة الوثائق السياسية (156), وسيعتمد هذا الكتاب في الإحالات؛ لأنه ذكر في أثنائه المصادر التي جمع منها شواهده التاريخية.
2- السابق (162).
3- السابق (231).
4- السابق (233).
5- السابق ( 326 , 250 ).
6- السابق (241).
7- السابق (246).
8- السابق (263).
9- السابق (245).
10- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية, مهدي رزق الله (243).
11- السابق (246).
12- السابق (248-251).











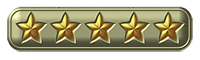




 المزاج
المزاج



